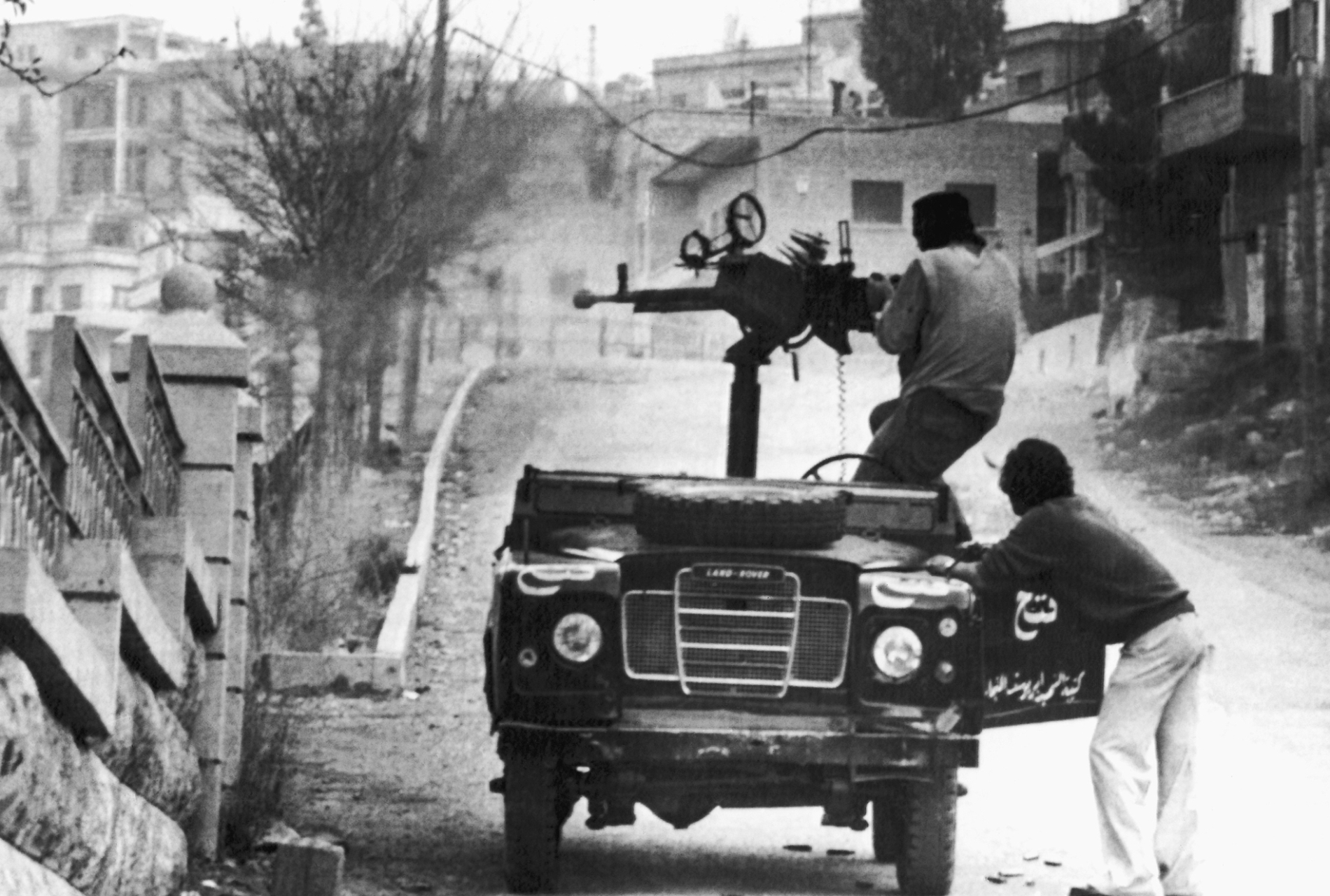بالتزامن مع انقضاء 50 سنة على بداية الحرب الأهلية الإقليمية في لبنان (13 أبريل/نيسان 1975)، وفيما تستمر حروب أهلية، إقليمية-دولية عدة، في بلدان عربية ولا تنطوي ذيولها في بلدان أخرى، يصدر للكاتب والباحث في الاجتماعيات والسياسات وضاح شرارة كتاب جديد عنوانه "الحروب الأهلية العربية المعاصرة.. نظاما سياسيا– بين عصبية الدولة ودولة العصبيات".
يوحي العنوان بأن العصبية، على معناها عند ابن خلدون، وبتحويرات وأشكال وألوان كثيرة، كانت ركنا أساسيا في تكوين الدول العربية المعاصرة، وأدى استمرارها وعملها في أبنية الدول إلى انفجار الحروب الأهلية فيها.
ويتناول الكتاب (يصدر قريبا عن "دار رياض الريس" البيروتية) بالسرد والتحليل أشكال ومسارات الحرب في بلدان ما سُمي "الربيع العربي". وفي هذه المناسبة تنشر "المجلة" حصيلة حوار مطول أجرته مع وضاح شرارة.
الميراث القديم
يعيد شرارة الرحم المولدة للحروب الأهلية إلى عدم إرساء السياسة في المشرق العربي على دولة تقر جماعاتُها بوازع يحول دون استرسالها في خلافاتها ونزاعاتها إلى حد خروجها على هذه الدولة وتقويضها. ويتمثل الوازع بأن لا تنزع هذه الجماعة أو تلك إلى السيطرة على جماعات أخرى بالاستتباع والغلبة.
وفي تشخيصه العلاقة بين الجماعات المنضوية في الدولة، يميز الباحث بين السيطرة بالاستتباع والغلبة المؤدية (على المعنى الخلدوني) إلى تقويض الدولة، وبين الهيمنة التي تتطلب توافق الجماعات على ترتيب مصالحها في وجهة تاريخية متماسكة، وعلى قيم مشتركة متقاسمة بينها، وتنظيمها الخلافات والنزاعات على نحو يفتح لها باب الحلول الجزئية واستيعابها وإدراجها في جهاز الدولة، بدل الخروج على الدولة والتعامل معها كعدو.