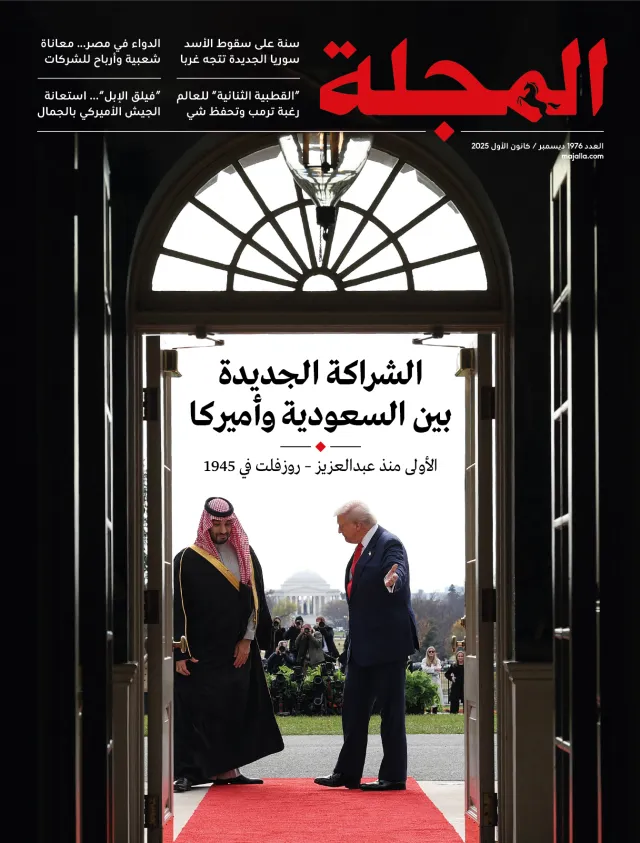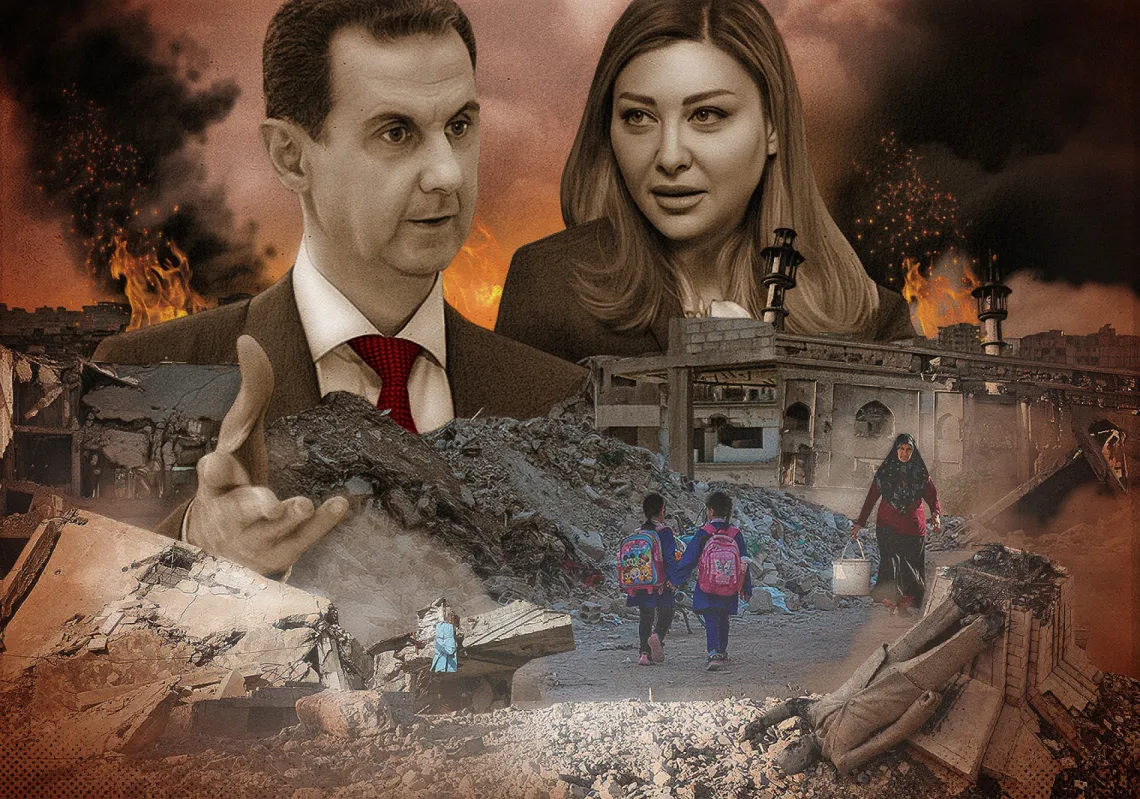يعد "الأراجوز" واحدا من أكثر الشخصيات شهرة في عالم الدمى المتحركة أو الماريونيت، إن لم يكن أشهرها على الاطلاق. وعلى الرغم من محدودية حركته، ارتبطت الشخصية في الأذهان بصورة من النشاط تصل إلى فرط الحركة أحيانا، ربما أثار هذا التناقض تساؤلا لدى البعض: ماذا لو تحرر الأراجوز من ثباته وانطلق بحرية؟ لم يكن ذلك مجرد خيال، بل تجسد على أرض الواقع مع تجربة الفنان المصري محمود شكوكو الذي بثّ في الشخصية وفي الفن الشعبي المصري، روحا مغايرة ومميزة قبل رحيله في مثل هذا اليوم في فبراير/شباط 1985.
الفنان الفصيح
في الأول من مايو/أيار سنة 1912 بينما يحتفل العالم بعيد العمال، رزق أحد أسطوات النجارة بحي الدرب الأحمر ويدعى ابراهيم اسماعيل موسى بمولود جديد، أطلق عليه اسم محمود، الذي سيعرف لاحقا بـ"شكوكو" بعد أن يرتبط اللقب –وهو من اختيار جده في إحدى الروايات- باسمه الفني والرسمي في وثيقة تحقيق الشخصية.
بحسب الرواية، كان الجد يواظب على تربية الديوك إلى جانب عمله بالنجارة، حيث كانت مصارعة الديوك من الألعاب الرائجة آنذاك بين أبناء الطبقة الشعبية. وعرف الصغير بموهبته في تقليد الأصوات من حوله، سواء من البشر أو الحيوانات والطيور في الحارة وفوق سطوح البيوت، وحين انتبه الجد إلى التشابه بين صوت حفيده وصياح أحد الديكة أطلق عليه لقب "شكوكو".
ويبدو أن الصغير لم يأخذ من الديك غرائبية الصوت فحسب، إذ أظهر تفوقا بين أقرانه في المناكفة والعناد حتى عدَّ من زمرة المشاغبين. نتج من ذلك تسرب مبكر من التعليم قبل أن يتمكن من فك الخط، لكنه في المقابل أتقن مهنة النجارة إلى درجة مكنته من صنع أثاث زواجه بالكامل. ومن الشائع أنه ظل محتفظا بعدة النجارة طوال حياته حتى بعد الشهرة، يمارسها بين آن وآخر ولو في صورة تصليح أحد الكراسي في البيت. من خلال هذه المهنة تشكلت الملامح الرئيسة لشخصية "شكوكو"، أحد أشهر نماذج الشخصية الشعبية، عصب النسيج للهوية المصرية في العصر الحديث.