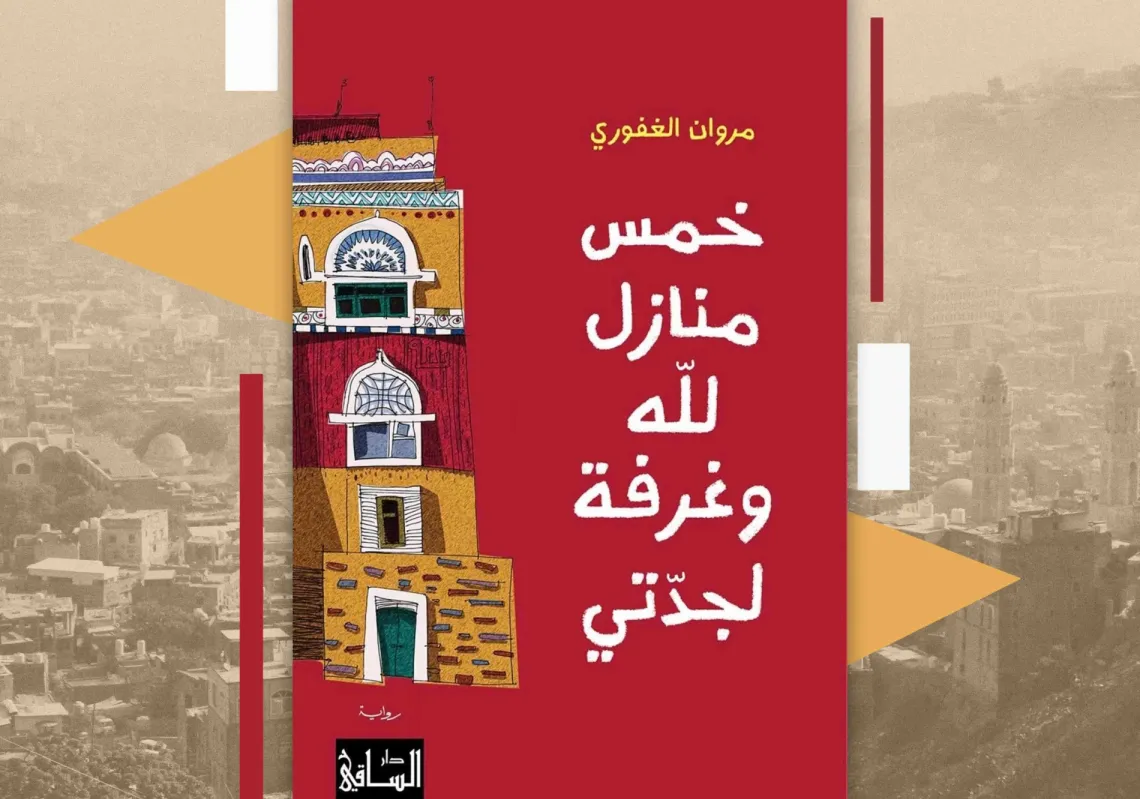القاهرة: منذ اكتشاف ما سمي العالم الجديد نشأت علاقة بين أميركا وأوروبا مرت بمنعطفات كثيرة، وبعد أن كانت بريطانيا تعاني عزلة تاريخية طويلة حيث يفصلها بحر عن اليابس الأوروبي ويحيط بها محيط يقود إلى المجهول، أصبحت في قلب طرق المواصلات إلى العالم الجديد، والفاصل المائي بينها وبين أوروبا وفر لها مناعة لقرون، خاضت خلالها صراعات متعددة مع قوى أوروبية. ومنذ القرن العشرين أصبحت بريطانيا عالقة بين فلكين: اليابس الأوروبي وأميركا الدولة/ القارة التي أصبحت تربطها بها «العروة الوثقى». والدولة الأميركية الفتية، التي لم تتسبب في إشعال أيٍّ من الحربين العالميتين، كانت الرقم الصعب في تحديد نهايتهما، وجاء انخراطها المتأخر في كل منهما طوق نجاة للديمقراطيات الأوروبية.
مشكلة الإكراهات الاستراتيجية
كانت سنوات ما بعد العالمية الثانية سنوات الاعتراف الأوروبي بالحاجة الماسة إلى أميركا: سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. لكن سنوات ما بعد انهيار العالم ثنائي القطبية شهد منعطفات مهمة أكدت- بعد اندلاع حرب أوكرانيا- أن الجغرافيا والأفكار ما يزالان يفرضان على المصالح قيودًا، وأن موسكو وواشنطن ما يزالان يضعان سقفًا من «الإكراهات الاستراتيجية» على اختيارات القارة العجوز، وأمام هذه الإكراهات تعود السياسة الأوروبية للانقسام بين «أوروبا أوروبية» تدعمها باريس، و«أوروبا أطلسية» تدعمها لندن، ومع انتخاب ليز تراس لرئاسة الوزراء في بريطانيا استُعيد- مبكرًا- استقطاب قديم/ جديد بين لندن وباريس. مونت كارلو الدولية (5 سبتمبر 2022) لخصت المشهد بتقرير عنوانه: «بعد انتخاب تراس: هل نحن أمام تاتشر جديدة تكره فرنسا وأوروبا؟»، وبحسب التقرير الإخباري تساءلت الصحف الفرنسية حول مستقبل العلاقات الفرنسية البريطانية خلال ولاية تراس، واستعاد الإعلام الفرنسي «مواقف سلبية تجاه أوروبا بشكل عام وفرنسا تحديدًا»، وقد سُئلت ليز بالفعل عن اسم رئيس الوزراء السابق الذي يحظى بإعجابها فكانت إجابتها محددة للغاية: مارغريت تاتشر.
وفي مقابلة معها قبل انتخابها بقليل (25 أغسطس/ آب) وردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «صديقًا أم عدوًا» أجابت تراس: «الموضوع لم يحسم بعد»!!
ورد ماكرون على هذه التصريحات بالقول: «نعيش في عالم معقد، تزداد فيه الديمقراطيات الاستبدادية، وقوى عدم التوازن... فإذا لم نتمكن، كفرنسيين وبريطانيين، من تحديد ما إذا كنا أصدقاء أم أعداء، فإننا نتجه نحو مشاكل خطيرة»!!

وبحسبThe New Statesman ، لدى تراس موقف مشابه لنهج المحافظين البريطانيين مثل مارغريت تاتشر، يتمثل في كراهية حقيقية للفرنسيين ذات جذور قديمة. وفي كتابه المرجعي: «العدو الأميركي: أصول النزعة الفرنسية المعادية لأميركا» يثير الباحث الفرنسي فيليب روجيه قضية من قضايا التاريخ الثقافي المهمة، وهي قضية يمكن أن تسهم في فهم جذور العداء الفرنسي للأنجلوسكسونية (بريطانيا ولاحقًا أميركا). يذكر روجيه أن بريطانيا العظمى، وألمانيا، وأسبانيا، وإيطاليا، وكلها دول خاضت الحرب ذات يوم ضد أميركا، أما فرنسا فلم تخض ضدها حربًا على الإطلاق، وهذا لم يمنعها من أن تكون البلد الذي يشهد نزعة عداء لأميركا «شديدة الحدة».. و«ثمة مقارقة عنيفة تجعل النزعة الفرنسية في معاداة أميركا لغزًا». (ترجمة بدر الدين عردوكي، مصر، 2005).
بينما ردود الفعل الإعلامية على إطلالة شبح تاتشر مرة أخرى تزداد، وصحيفة «لوبينيون» الفرنسية اعتبرت أن التعامل السلبي مع الفرنسيين شائع لدى تيار داخل المحافظين، وبالتالي ترى تراس أنه من المفيد الوقوف ضد الاتحاد الأوروبي وفرنسا، وهي تنتمي إلى «جزء يميني للغاية داخل حزبها وهي تفضل الآيديولوجيا على النمو الاقتصادي». ومنذ بدأت سيرة الوحدة الأوروبية كانت فرنسا- في عدة عهود رئاسية- تتبنى سياسات تركز بشدة على تغذية نزوع «استقلالي» في الاتحاد الأوروبي، فيما يتصل بالعلاقة مع أميركا. وفي «القمة الأوروبية الأولى» في باريس (10 فبراير/ شباط 1961) دُشنت مسيرة تطوير الاتحاد الاقتصادي نحو صيغة للتعاون السياسي بمبادرة من الرئيس الفرنسي شارل ديغول. وكانت المبادرة تعني التخلص مما يسميه بعض المتحمسين لـ«أوربة أوروبا»: التخلص من الوصاية الأميركية، وتهميش بريطانيا نهائيًا ووضع مستقبل أوروبا في أيدي دولها وليس في يد منظمة تتجاوز سلطتها سيادة الدولة. وفي 1966 وجهت فرنسا ضربة قوية للتوجه الذي تتبناه بريطانيا بقوة: «أوروبا الأطلسية»، إذ قررت الانسحاب من الجناح العسكري للحلف.
وقد شهد العام 1998 واقعة ذات دلالات بالغة الخطورة لجهة المساعي الفرنسية لتقليص العلاقات الأوروبية الأطلسية، ففي تقرير إخباري بثته وكالة الأنباء الكويتية (29 سبتمبر/ أيلول 1998) زار المستشار الألماني غيرهارد شرودر باريس حيث ناقش الرئيسان قضايا بينها معرفة ألمانيا «بعرض المظلة النووية الفرنسية على ألمانيا من خلال وسائل الإعلام». وبعد 44 عامًا عادت إلى الجناج العسكري للحلف في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي الذي كان خصومه السياسيون يطلقون عليه تهكمًا، بسبب علاقته الجيدة مع أميركا: «ساركو الأميركي»!!
التاتشرية القديمة والجديدة
في منصبها كوزيرة دولة للتعليم والعلوم في حكومة المحافظ إدوارد هيث ألغت برنامجًا يوفر الحليب المجاني لأطفال المدارس، ما أثار عاصفة جدل، وهو بداية النهج الصارم في تطبيق قواعد «النيوليبرالية الاقتصادية» الذي أصبح سمة مميزة لحكمها. وبدعم من الجناح اليميني المحافظ، انتخبت لزعامة الحزب في فبراير 1975 وبدأ صعودها لمدة 15 عامًا غيرت خلالها وجه بريطانيا. قادت تاتشر المحافظين إلى فوز انتخابي حاسم في عام 1979 ووضعت حدًا لما أطلقت عليه: «التدخل الحكومي المفرط في الاقتصاد»، وجاء مصطلح «التاتشرية» للإشارة، ليس فقط إلى هذه السياسات، بل أيضًا إلى جوانب من نظرتها الأخلاقية وضمن ذلك القومية المتشددة والنهج القتالي الذي لا هوادة فيه لتحقيق الأهداف السياسية. وفي الشؤون الخارجية ساهمت مع الرئيس الأميركي رونالد ريغان (1981-1989) في جعل ثمانينات القرن الماضي: «عشرية المحافظين» وتبنت رؤية للعالم تقوم على عداء شرس للاتحاد السوفياتي، وأكسبها خطاب ألقته عام 1976 يدين الشيوعية لقب: «المرأة الحديدية» في الصحافة السوفياتية. وقد دعمت تاتشر بقوة حلف الناتو والرادع النووي المستقل لبريطانيا. وقد تميز النصف الثاني من فترة ولاية تاتشر بجدل متواصل حول علاقة بريطانيا بالجماعة الأوروبية. في عام 1984، نجحت، وسط معارضة شرسة، في تقليص مساهمة بريطانيا في ميزانية المفوضية الأوروبية بشكل كبير. وبعد فوزها في انتخابات عام 1987، تبنت موقفًا أكثر عدائية تجاه الوحدة الأوروبية، وقاومت الاتجاهات القارية الفيدرالية نحو عملة موحدة واتحاد سياسي أعمق. ولعل قولها: «لم نقلص حدود سلطة الدولة بنجاح في بريطانيا حتى نرى سلطة جديدة تفرض علينا من أوروبا عن طريق دولة تبسط سلطتها من بروكسل». (1988)، يلخص جذور الفجوة الكبيرة بين لندن وباريس خلال حكمها.

وبعد البريكست والمسار الذي اتخذته العلاقة مع روسيا، مع سيطرة المحور الفرنسي الألماني على مقدرات القرار الأوروبي، وبخاصة فيما يتصل بخطوط إمداد الغاز الروسية، تعزز موقف السياسيين الأوروبيين المؤيدين لشراكة أوروبية/ أطلسية أكبر، في مواجهة محاولات تمتد إلى ما بعد زوال الاتحاد السوفياتي في نهاية تسعينات القرن الماضي، لبناء منظومة أمن أوروبية مستقلة عن الناتو. وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 1997 كانت العلاقات الأميركية الأوروبية على موعد مع زلزال كبير، حيث طرح للمرة الأولى علنًا في تقرير أصدرته لجنة تقييم المعلومات والتقنية التابعة للاتحاد الأوروبي اسم شبكة التجسس الأنجلوسكسونية «إيشليون». وقد أكد التقرير الذي حمل عنوان: «تقييم تقنيات التحكم السياسي» أن هذه الشبكة جزء من النظم التي حددتها اتفاقية «UKUSA» التي أبرمت بين أميركا وبريطانيا وكندا وأسترليا ونيوزيلندا عام 1947 للتعاون في ميدان الأمن القومي، وقد تم تطويرها أيام الحرب الباردة لرصد المعلومات غير العسكرية، ولذا فهي توجه للتنصت على أعمال الحكومة والأفراد والشركات في كل أنحاء العالم. وقد أكدت هذه الواقعة الصادمة لكثير من الأوروبيين أن الحلفاء الأوثق لأميركا ليسوا أعضاء حلف الناتو بالضرورة بل من ينتمون إلى التشكيل الحضاري الأنجلوسكسوني، ما عزز التيار الداعي إلى سياسات أوروبية أكثر استقلالية عن أميركا.
وعلى سبيل المثال، نشر معهد بروكنجز الأميركي مقالًا لإيفو إتش دالدر (المسؤول الأميركي السابق في حلف الناتو)، قبل عام من «هجمات 11 سبتمبر» (1 سبتمبر 2000)، يكشف فيه عن تصدعات في العلاقات الأميركية الأوروبية. دالدر تحدث عن واقع لا يعكسه الإعلام وهو أن «كل شيء ليس على ما يرام»، وقرار الاتحاد الأوروبي بتعزيز قدرته على العمل الأمني والدفاعي المستقل يقلق واشنطن. و«الجدل الأمني الناشئ عبر الأطلسي ينطوي على سؤال أكبر تجنبه الطرفان حتى الآن». ورغم أن مهمة «الدفاع الجماعية» للحلف لا تزال هدفًا مركزيًا، فإن وظيفته الأساسية بحسب قمته الخمسين (أبريل/ نيسان 1999) تتمثل في توسيع الأمن والاستقرار إلى أجزاء أخرى من أوروبا، وفي هذه المرحلة عارضت لندن الدور الدفاعي للاتحاد الأوروبي!
ورغم اللغة السياسية الذكية على جانبي المحيط الأطلسي في بيانات الناتو والاتحاد الأوروبي أرسلت رسائل طمأنة متبادلة، إلا أن القلق لا يزال مستمرا عبر الأطلسي. وقد كانت «هجمات 11 سبتمبر» أحد العوامل الرئيسية في طي صفحة المخاوف، ومنح الحلف دفعة قوية لتجاوز أسباب الفتور. وقد جاء الموقف الفرنسي الألماني المعارض للغزو الأميركي للعراق (2003) مقابل الانخراط البريطاني الكبير في المواجهة مع نظام صدام حسين ليؤكد أن المسافة تتسع بين أنصار «أوروبا الأوروبية» في باريس وبرلين، وأنصار «أوروبا الأطلسية» في لندن وواشنطن. وقد شكل التوجه الذي دشنه المستشار الألماني جيرهارد شرودر بتوقيع اتفاقية بناء خط الغاز «نورد ستريم 1» (8 سبتمبر 2005)، منعطفًا لم تتكشف أبعاده إلا مع نشوب الحرب الأوكرانية. ولاحقًا أصبح شرودر أحد كبار مسؤولي الشركة المالكة للخط، وفي 2019 انتقد شرودر العقوبات الأميركية ضد «نورد ستريم 2» مؤكدًا أن «ألمانيا ليست تابعة لواشنطن». وقال شرودر في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية (31 ديسمبر/ كانون الأول 2019): «أميركا تريد أن تحدد مع من ينبغي أن نمارس تجارتنا... ينبغي أن لا نقبل ذلك»، نحن لسنا ولاية أميركية.
حرب أوكرانيا مأزق وفرصة
وفي مشهد يشبه إلى حد كبير مشهد التململ الصامت في العلاقات الأميركية الأوروبية، كان العام 2021 يشهد فتورًا، بل مخاوف حقيقية، من مستقبل غامض لعلاقات الشريكين. وفي تقرير أصدرته في 2021 مؤسسة راند الأميركية
(European Strategic Autonomy in Defence: Transatlantic visions and implications for NATO, US and EU relations, Lucia Retter, Stephanie Pezard, Stephen J. Flanagan, Gene Germanovich, Sarah Grand-Clement, Pauline Paillé)
رأت نسبة كبيرة من الخبراء الأميركيين الذين التقاهم معدو التقرير، أن دعامة أوروبية قوية إلى جانب الناتو مفيدة لجميع الأطراف، وتعني المزيد من قوة الناتو، وبخاصة في أجواء المنافسة السياسية العالمية الشديدة. وعلى العكس من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي القوي الذي يتجاهل حلف الناتو أو يعمل منفصلًا عنه هو تهديد للعلاقات عبر الأطلسي. وبعض الخبراء الأميركيين اعتبروه سببًا محتملًا لفقدان أميركا نفوذها في أوروبا. وعلى الجانب الآخر، تشير تقارير كثيرة إلى أن الدافع الرئيسي وراء المساعي الأخيرة لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، ارتبط ارتباطًا وثيقا بأزمة الثقة التي تسببت فيها سياسات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وبينما قد يكون هناك ارتياح داخل الاتحاد الأوروبي بعد انتخاب الرئيس جو بايدن ورغبته المعلنة في إعادة تأسيس تعاون وثيق مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين، هناك أيضًا شعور قوي بين الأوروبيين الذين التقاهم معدو التقرير، بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج لمواجهة احتمال تكرار تجربة ترامب في المستقبل القريب. وبناءً على ذلك فإن التصورات الدفاعية الأوروبية مدفوعة بالرغبة في التحوط ضد شبح ترامب. والحرب كما هددت الأمن الأوروبي أدت- كما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر– إلى تعزيز تماسك الحلف وكذلك العلاقات الأميركية الأوروبية على نحو غير مسبوق.

وبعد التطورات الدرامية أوروبيًا، فإن الذي يبدو من المشهدين الأوروبي والبريطاني أن القارة انزلقت على منحدر الحرب الأوكرانية، والكلفة الاقتصادية وكذلك التداعيات السياسية للحرب– على الأرجح– فاجأت الجميع، صحيح أن أميركا أمسكت «اللحظة الأوكرانية» بقوة واستخدمتها في ترميم تصدعات الناتو، لكنها فشلت إلى حد كبير في توقع الكلفة الاقتصادية التي يمكن أن يدفعها الغرب (والعالم) نتيجة الرد على الغزو الروسي بتصعيد سياسي وعسكري شامل، فضلًا عن عقوبات اقتصادية شملت آثارها– غير المباشرة– كل دول العالم تقريبًا، ولذا فإن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لن تكون قادرة على تجاهل الآثار الكبيرة للحرب وتداعياتها على الداخل البريطاني. والتضخم وحده يمثل تحديًا كبيرًا للمواطن البريطاني بدأ بالفعل يدفع عجلة إضربات قد تهدأ لتشتعل من جديد، و«السياسات التاتشرية»– أيًا كانت درجة القناعة بوجاهتها نظريًا– هي آخر ما يمكن الاعتماد عليه لمواجهة الأوضاع الراهنة.
وفي عدة عواصم غربية في مقدمتها واشنطن، شهدت السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية (2008) إنفاق ما يزيد على خمسة تريليونات دولار لاحتواء آثارها، في خروج صريح على قواعد «النيوليبرالية التاتشرية»، بل إن التحالف بين «البيت الأبيض»، و«داوننج ستريت» خلال حكم ريجان وتاتشر، كان شرطًا موضوعيًا لتحول سياستيهما إلى خيار وطني ودولي في آن واحد. وقد كان «إجماع واشنطن» (1989) ترجمة لهذا التوافق عبر الأطلسي. أما اليوم فإن الحليف الأميركي يتجه إلى سياسات اقتصادية مختلفة تتضمن إنفاقًا اجتماعيًا أوسع وعولمة هي الأولى من نوعها لضرائب الشركات.. وغيرها من الإجراءات المماثلة. وعليه فإن التشدد في مواجهة روسيا، ومزيد من الخيارات المحافظة في التعاطي مع ملفات اجتماعية وسياسية، قد يكون الممكن إحياؤه من التاتشرية، هذا طبعًا بالإضافة إلى تأكيد خيار أوروبا الأطلسية على حساب أوروبا الأوروبية. والسجال المبكر مع باريس أول الغيث!
* باحثة في العلوم السياسية- مصر.