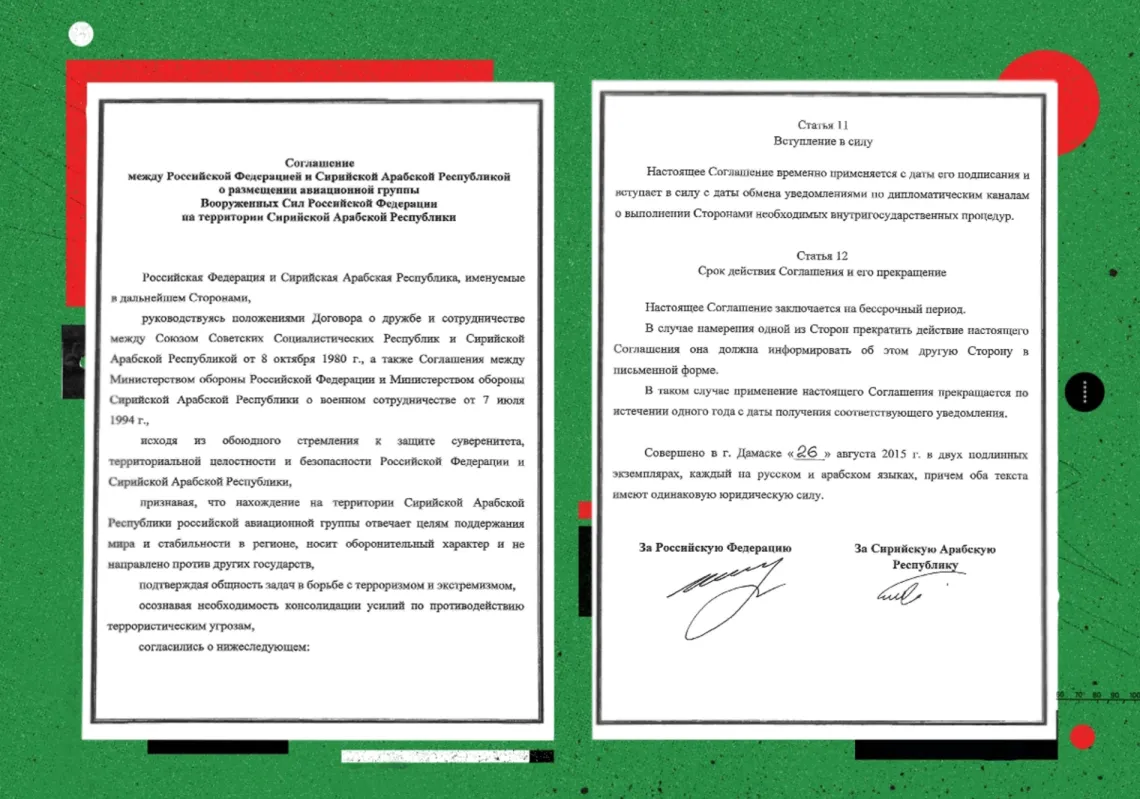بقلم منصف المزغنّي وريشة علي المندلاوي
قال قلبه: تعبت من النبض يا علي
ماذا تقول الكلمات في حضرة غيابك أيها الحاضرُ الذي لا يغادر الوجدان، يا علي إبراهيم، أيها المعلم الاستثنائي؟
إنّ جريدة «الشرق الأوسط» وأخواتها من مطبوعات تبكي بالحبر الساخن وبدموع الصبر على فقدان قلب مثل قلبك الكبير.
الكل يذكر كم كنت ودودًا، وكم كانت ضحكتك الخصوصية ذات إيقاع ساحر في مناخ العمل، وفي إيقاع الجريدة منذ أن تبدأ مادتها اليومية في التشكل والتصوّر حتى لحظة ذهابها إلى المطبعة.
لقد ذهب في ظنّ العاملين معك أنك رجل بلا متاعب خاصة، فلم يسمع من عمل معك عبارات التأوّه، أو الملل، والإعياء في مهنة المتاعب الأبدية، بل إن زملاءَك في العمل كانوا يرجون منك أن تأخذ نصيبك من الراحة، وكنت تقاتل من أجل الحرص على العمل.
***
يذكر أحبابك يوم قرروا، في الجريدة أن يفاجئوك بالاحتفال بعيد ميلادك، في طقس حرصتَ فيه أن تكون عنوانَ تواضعٍ ونكرانِ ذات، وكأنك كنت تقول لهم:
«الحقّ. يا جماعة، أقول لكم، إني ولدت يَوْمَ دخلتُ إلى جريدة «الشرق الأوسط» ، وأما عيد ميلادي فهو يومي ويقاس برضا القرّاء على الأداء الصحافي».
برحيلك الموجع، افتقدتْ أسرتك في الجريدة إنسانا وُلِد لكي يكون صحافيا من فئة العشاق، وشاء القلب أن يفاجئك بنوبة أولى، في 14 فبراير (شباط) الموافق لعيد الحب العالمي العام الماضي، وتُنقل إثرها إلى المستشفى، لقد قال لك القلب كلمته التي لم تُرِدْ أن تصغي إليها:
«إنّي تعبتٰ من النبض يا علي»
ولكنك قررتَ، قدر المستطاع، أن تسير عكس ما يُمليه القلبُ والطبُّ.
فهل كنت لا تستطيع أن تتصور أنَّك حيّ، وسليم، ومعافى إلا مقسّما بين أسرتيْن:
الأولى في البيت حيث زوجتك الفاضلة السيدة تفيدة والبنات الثلاث: نهى وسلمى وشيرين، والثانية في «الشرق الأوسط» الجريدة التي وهبتها نَفْسَك الكبيرةَ، فكنت لا تتركها إلاّ بعد الاطمئنان على أنّ الشغل ليس «تمام» وحسب، بل «تمام التمام».
***
ولكن لأنك، في الأصل عاشق أصيل. بعد حادثة القلب الأولى، صرتَ على كرسي متحرك، وأبيتَ أن تتنازل عن الحركة والبرَكة، فهل كنت تخاطب الكرسيّ:
«لستُٰ لك، ولستَ لي، ولنْ أرضخ لإغراء الراحة»، وصرتَ تنتقل بين أقسام الجريدة، كعهدك أيام العنفوان، تراقب الشقائق والرقائق، وتعتني بالتفاصيل الشاردة والواردة، وتقوم بجولتك على الكرسي، كم كنتَ أكبر من الكرسيّ! وكم كان المرض عاجزًا عن إعاقتك، ولعله كان خَجِولا من نفسه، لأنه بات ساكنًا فيك، وكنت رافضًا له، وكأنّ المرض يريد أن يعتذر لإرادتك، وكم كانَ مهزومًا لأنه لم يكن في مقدوره أن يضطرَّك إلى التقاعد والقعود.
وأمّا أنت فلم تقدر إلا أن تتفهم شغلَ المرض، وتردّد في سرّك أمام العمل الصحافي الذي يُنْهي ولا ينتهي: «صحَّ مني العزْمُ والجسمُ أَبَى».
وكانت ابتسامةُ روحك تحتقر رغبة المرض في أن يبعدك عن شغلك، وترسم وردة حبّ لـ«الشرق الأوسط» جريدتك التي بادلتكَ حبًّا بحبّ.
***
عشتَ ما زاد عن ربع قرن في جريدتك «الشرق الأوسط»، وكنتَ نموذجا للتفاني الذي لا يعرفه إلا الكرماء من طينة الوفاء ومعدن العطاء، وزملاؤك يقولون لك: «نتذكرك، يا أستاذنا علي إبراهيم، راحلا عزيزا، أحبك الجميع بلا استثناء لأنك استثنائي في الصحة والمرض، فلن ننسى أنك شعلة من حماس، ولا شغل للشعلة فيك غير الاشتغال:
أهملتَ، ما استطعت نصائح الأطباء بالراحة، والنقاهة، وملازمة الفراش، فأنت تستغرب من الراحة لأنك ابن أصيل لمهنة المتاعب.
***
كم كنت تشبه سمك السلمون الذي يظل يسبح ضد التيار في رحلة العودة إلى مسقط رأسه، لا لشيء إلا ليموت حيث ولد.. فكنت تعاند تيار المرض وتقاوم إلى أن جاءت نوبة القلب الثانية والأخيرة في مكتبك أيضًا، بجريدة «الشرق الأوسط» قبل أيام من 7 يونيو (حزيران) الماضي حيث لقيت ربك لتؤكّد أنك فيها ولدتَ.
***
لقد كنتَ صديقًا للعلم والمعرفة، وصاحب القلم المنتَظَرة مقالاته، ورافعًا راية الاطلاع والسؤال لفهم عالمنا الذي ازداد تعقيدًا، وأخباره التي تتواتر بِنَسَقِ الطوفان.
وهل كان الشاعر العربي القديم يقصدك وأمثالك بهذه الكلمات:
أخو العلمِ حي خالدٌ بعد موتهَ ... وأوصالُه تحت الترابِ رَميمُ
وذو الجهل ميْتٌ وهْو حي على الثرى ... يُعَدُّ من الأحياء وهو عديمُ
***
السلام على روحك الطاهرة وأخلاقك الباهرة
والصبر الجميل لأسرتك الصغيرة ولأسرتك في الصحافة، ولقرائك الذين أدمنوا على مقالاتك وأحبوك، وفجعوا بهذا الرحيل المبكّر.
يا أيها العزيز، يا علي إبراهيم، أنت لا تصلح للنسيان لأنك طيب الذكر وأخضر الحبر. والذين عرفوك، بأسلوبك، وفكرك الهادئ والنبيل، يغالطون أوجاعَ الرحيل ويردّدون في صبر:
وما الدهرُ إلاّ جامعٌ ومفرِّقٌ ... وما الناسُ إلاّ راحلٌ ومودَّعُ.